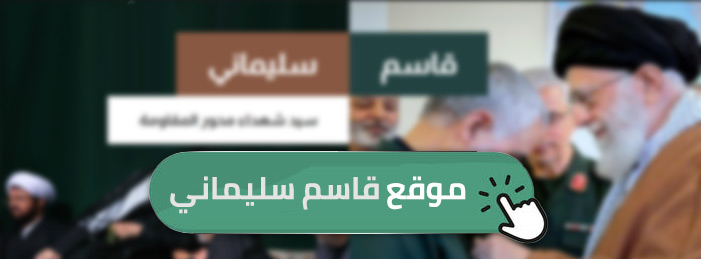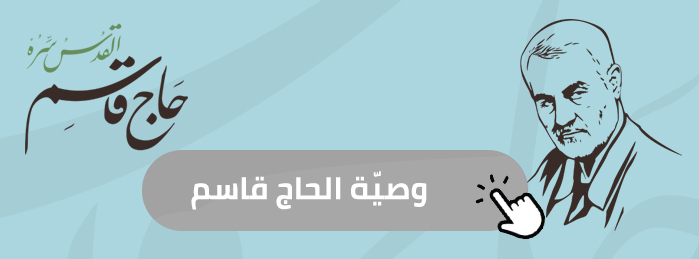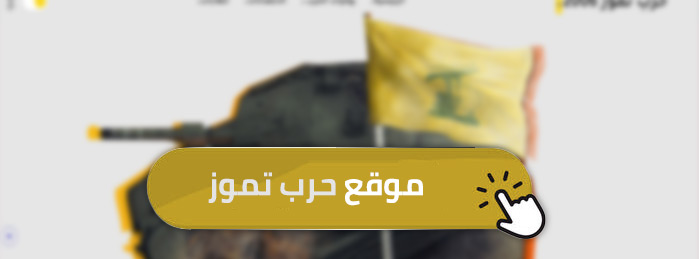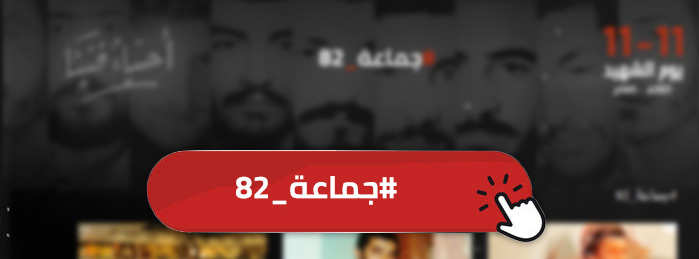آراء وتحليلات
أليزابيث وابن خلدون.. وتيه العقل العربي
أحمد فؤاد
"إن المغلوب مولع أبدًا بالاقتداء بالغالب، في شعاره وزيّه ونحلته وسائر أحواله".. مقدمة ابن خلدون ـ الجزء الثاني ـ الفصل الثالث والعشرين.
حين عاصر أحد أهم مفكري وعلماء الحضارة الإسلامية، ابن خلدون، مقدمات التراجع الحضاري للأمة الإسلامية، وبدايات التقهقر والانسحاق أمام أوروبا، كان طبيعيًا أن يخصص جزءاً من مقدمته ـ أشهر كتبه على الإطلاق ـ للحديث عن انقلاب الدول وتغير الأحوال وأسباب شيوع الخراب في بلاد الشرق.
وضع ابن خلدون ما رآها مظاهر أولية للتراجع وفقدان الريادة الحضارية، وتتلخص في اتجاه الأمم المغلوبة على أمرها إلى التعظيم من شأن أعدائها، وإسباغ صفات الكمال والسمو على عاداتهم وتقاليدهم وتصرفاتهم، والانشغال بتقليدهم، حتى بتصرفات الحياة اليومية والمأكل والملبس، وهو ما كان واقعًا حينذاك في دول المغرب العربي، ثم تسلل بهدوء وتأنٍّ إلى القلب العربي الصلب في مصر والشام والعراق.
كان رد الفعل المباشر من الفيلسوف المسلم الأشهر والأهم، هو محاولة الإجابة عن سؤال رآه محور الواقع، وكتب ردًا على سقوط فردوس الأندلس، والتي كانت منارة وبقيت لقرون مركز إشعاع حضاري، يأسر ألباب الأوروبيين ويحرق قلوبهم حسدًا وغلًا، حتى بلغت المواجهة الحضارية ذروتها في القرن الخامس عشر، وكانت خسارة العالم الإسلامي فادحة وقاصمة، أو "كأنما نادى لسان الكون في العالم بالخمول والانقباض فبادر الإجابة"، كما يصف ابن خلدون.
حاول ابن خلدون صناعة وتأسيس وعي تاريخي إسلامي، ومنح هذا الوعي الأدوات التي يستطيع بها تفكيك شيفرة عالم متغير بسرعة، وفيما كان الخمول عنوان الشرق كان التوهج الغربي قد بدأ لتوه، يخطف العيون والقلوب، ويجعل من مسألة السيادة الحضارية لأوروبا مسألة وقت فقط، وهو ما حدث بعد ذلك.
عاصر ابن خلدون أحداثًا عظمى، كانت فاصلة بين تاريخين في الحضارة العربية الإسلامية، واجتهد في وضع رؤية عامة وشاملة تتيح قراءة التاريخ بعقلانية ووعي، وذلك بتجريده مما لحق به من حكايات مصنوعة أو خرافات مستدخلة، ليكون أول من طبق المنهج العلمي في بحث الظواهر الاجتماعية وآثارها على الشعوب والدول، في كتابه "العبر وديوان المُبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر"، والذي عُرف اختصارًا بـ "تاريخ ابن خلدون"، ومقدمة هذا الكتاب الشهيرة بـ "مقدمة ابن خلدون" والتي تعد كتاباً قائمًا بذاته.
ولعل أعظم إنجاز فكري لابن خلدون في هذه النقطة، كان استخراج معنى التبعية الاجتماعية/الاقتصادية عند الأمم المنتصرة، في مقابل التقليد الذي يعده خللًا في الأمة المهزومة، ضرب أعصابها العارية بما لا تستطيع تحمله، فكشف عن كل نواقصها وأزماتها، من تحجر الفكر إلى تفكك المجتمع وفساد الحكم وتجبره على الداخل، فيما يمارس نفس الحكم الانسحاق أمام العدو الخارجي.
ولم يكن غريبًا والحال كذلك، أن تكون الترجمات الأوروبية للكتاب والمقدمة أسبق وأسرع وصولًا إليهم وانتشارًا بينهم من العالم العربي والإسلامي، إذ بدأت الترجمة الواسعة للكتاب بفضل جاكوب خوليو، الذي تتبع فكر ابن خلدون وألّف كتابه المعنون رحلات ابن خلدون عام 1636، وترجم إلى أغلب اللغات الأوروبية حينذاك، اللاتينية والفرنسية والإنجليزية واليونانية.
وإلى قرون طويلة بعد، كانت النخبة العربية في طليعة مقلدي الغرب والساقطين في هواه، ولعبت البعثات التعليمية التي أرسلها عدد من الدول العربية إلى أوروبا الدور الأكبر والأول في خلق وتمتين قاعدة جديدة من المفكرين والمؤثرين، لا يرون في الغرب إلا كل خير وتقدم، وهم من حيث ارتبطوا نفسيًا بالسيد الغربي، فقد فقدوا جذورهم العربية/ الإسلامية، وأمام كل كلمة مدح تخرج منهم للحضارة الغربية، فقد أدمنوا احتقارنا والتقليل منا كشعوب ودول، بل واستساغوا احتلالنا من قبل "فاعل الخير" الأوروبي، الذي جاء ينتشلنا من أزمتنا الحضارية ويلحقنا به.
ولعل النموذج الأبرز، أو الجد الأكبر، للنخب المتغربة الحالية، هو العالم الأزهري رفاعة الطهطاوي، الذي أرسله والي مصر محمد علي إلى فرنسا، كمرافق وواعظ للبعثة الطلابية لدراسة علوم الهندسة والطب وفنون الصناعة الحديثة، فإذا بالحضارة الفرنسية الفوارة بالتقدم والغنى تأسر قلب الطالب الأزهري الخام، ليصمم على تعلم اللغة الفرنسية والإلمام بجزء من المعارف التي جاءت البعثة لها، وقضى 5 سنوات كاملة في التحصيل ليعود في عام 1931 بشهادة في الترجمة، ومعها مخطوطة كتابه الشهير "تخليص الإبريز في تلخيص باريز".
ويقوم الكتاب على الفكرة التي حذر منها ابن خلدون قبل ذلك بقرون طويلة، ووضع فيه ما رآه مقومات تفوق المجتمع الفرنسي، وأسباب ريادته وتقدمه على كل الأصعدة، واصفًا ما عاينه في باريس من أنه "إسلام بلا مسلمين"، وفي مقابل ذلك وصف بلاده بأنها "بلاد مسلمين بلا إسلام".
5 سنوات فقط، بعقل منبهر أضاع قدرته على التفكير المستقل والشك والبحث الدؤوب، أنتجت لنا ما يمكن اعتباره دستورًا مقدسًا لدى كل النخب المتغربة في بلادنا، وكما أن الطهطاوي أرجع كل أزمات العرب والمسلمين إلى قلة الوعي والبعد عن الأخذ بأسباب التحضر والرقي، والتي يمثلها في فكره المجتمع الأوروبي/ الغربي، فإن الخطاب المتغرب لا يزال ينهل من النبع الفاسد ذاته، ويلقي علينا حلوله للأزمات، بالالتحاق تمامًا بالغرب، وصولًا إلى جعلنا صورة عبيد منزل للغربي المتفوق.
لكن الأغرب في حكاية رفاعة الطهطاوي لم تكن فقط أفكاره، بل اعتباره مرجعًا فكريًا تقدميًا، بفعل إنشائه وإدارته لمدرسة الألسن (كلية الترجمة)، من جانب الإعلام الرسمي، وتناسى الطرفان، الدولة والطهطاوي، أن الغرب صنع تقدمه على جثثنا، وأنه قبل سنوات قليلة جدًا من بعثة الطهطاوي الأزهري، كانت مدافع نابليون تحصد أهالي القاهرة الثائرة في وجه قواته، كما كان الجنود الفرنسيون، رُسل الحضارة والتقدم، يحولون الأزهر الشريف بتاريخه وموقعه الديني الكبير إلى حظائر لخيولهم!
وكما كانت النهضة قائمة على أسس واهية، وأفكار عطنة بالية، فإن نهايتها جاءت أسرع مما تصور أكثر المتشائمين، فقد انهارت إمبراطورية محمد علي في حياته، وبتدخل أوروبي جمع بين إنجلترا وفرنسا، وأُجبر على تفكيك الصناعات الناشئة بفتح الباب أمام الاستيراد من أوروبا، ومنح حماية للرعايا الأوروبيين في مصر، وكذلك فإن خليفته عباس الأول قرر نفي الطهطاوي إلى السودان، لتغلق نافذة في الاتجاه الخاطئ على التحديث كما يراه المتغربون.
ومن القديم إلى الحديث، كانت فاجعة التعزية العربية الرسمية لبريطانيا في وفاة ملكتها العجوز أمرًا موجعًا ولافتًا للنظر، عن حجم الاختراق النفسي لمجتمعاتنا، بمثل ما مثله الطهطاوي أو حذر منه ابن خلدون، وبدا كأن هناك شيئاً مستترًا لا نعرفه عن العلاقات البريطانية العربية، غير وعد بلفور بالطبع.
الإعلان العربي الرسمي، والذي وصل لحد الحداد على ملكة دولة لطالما تسببت في نزيف الدم، في كل بلد عربي، لا يقول أكثر من أننا استوردنا الفكرة واستوردنا الحزن واستوردنا العقول التي نفكر بها، فمن يقول إن على رئيس مصر ـ مثلًا ـ أن يقدم تعازيه لمن وصفها بالأمة البريطانية في وفاة ملكتها، وإسباغ أعظم الصفات عليها، وهذه الملكة بالذات هي صاحبة القرار الأخير بالتدخل العسكري الإنجليزي في العدوان الثلاثي على مصر، والملكة أليزالبيث هي التي وقعت على قرار التدخل العسكري في مصر، كما حدث بعد ذلك في أفغانستان والعراق، وقائمة تطول من الدول العربية والإسلامية، والذي أدمى القلب العربي بشدة، وكان سببًا في مئات الآلاف من الضحايا الأبطال، ممن عرفوا أن مصيرهم ـ حاضرًا ومستقبلًا ـ لا يعتمد على تقليد الغرب أو احترامه، بقدر ما يقوم على مقاومة الغرب والانتصار عليه.
والدستور البريطاني غير مكتوب، كما دستور الكيان اللقيط بالضبط، وهو مجموعة من التقاليد البريطانية الراسخة وترسانة من القوانين القديمة، تجعل من الملكة أو الملك القائد الأعلى للجيوش، بجانب القسم العسكري الخاص بالملكة وضرورات الطاعة والانصياع لها.
هذه الأصوات النشاز، الناعقة بطلب الرحمة لمن كانت توزع الموت على آلاف المسلمين المدنيين في قراهم ومدنهم ودولهم، هي ذاتها الأصوات التي تطالب بالتوقف عن مقاومة الكيان الصهيوني، أصحاب الجلود السميكة وأبناء تزاوج حرام بين عقليات متأخرة ونظريات فاسدة، وهؤلاء ـ قبل العدو الحقيقي ـ سبب كل نكبة وأزمة في دولنا العربية اليوم.
إقرأ المزيد في: آراء وتحليلات
19/04/2024
هل ردّت "إسرائيل" على إيران؟
17/04/2024
عملية عرب العرامشة: الصفعة المؤلمة
17/04/2024
"الوعد الصادق" ونهاية الملاذ الآمن
التغطية الإخبارية
كتائب شهداء الأقصى - طولكرم: يخوض مقاتلونا منذ مساء الأمس اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الصهيوني في عدة محاور
الخارجية السورية: العدو يستهدف استقرار وسلامة دول المنطقة لجرِّها إلى أتون حربٍ إقليمية
البحرين: تظاهرة في منطقة المقشع نادت بالحرية لمعتقلي الرأي
سرايا القدس- كتيبة جنين: استهداف معسكر سالم العسكري وإصابة آلية عسكرية من نوع 'هامر'
لبنان: استئناف العمل في قسم جونية التابع لمصلحة هيئة إدارة السير اعتبارا من الثلاثاء
مقالات مرتبطة

موقع بريطاني: لأول مرة يحارب "الجيش العربي" دفاعًا عن الاحتلال

ليفركوزن بطلًا للدوري الألماني وتعثّر لأرسنال وليفربول في إنكلترا

عبد اللهيان: أزمات المنطقة تنبع من الدور المخرِّب للكيان الصهيوني

بريطانيا مُصرّة على إمداد العدو بالأسلحة

درّة المدمّرات البريطانية تتحطّم تحت مقصلة اليمن

الفائز ببطولة "الباور ليفتنغ" لـ "العهد": أهدي الفوز للمقاومين في جنوب لبنان

عيون في السماء: الأقمار الاصطناعية عالم مذهل

بانوراما 2023 | في وداع عام "سقوط الأقنعة" واستقبال "عام الضباب"

مبادرة عالمية من لندن تدعو لوقف العدوان على غزة